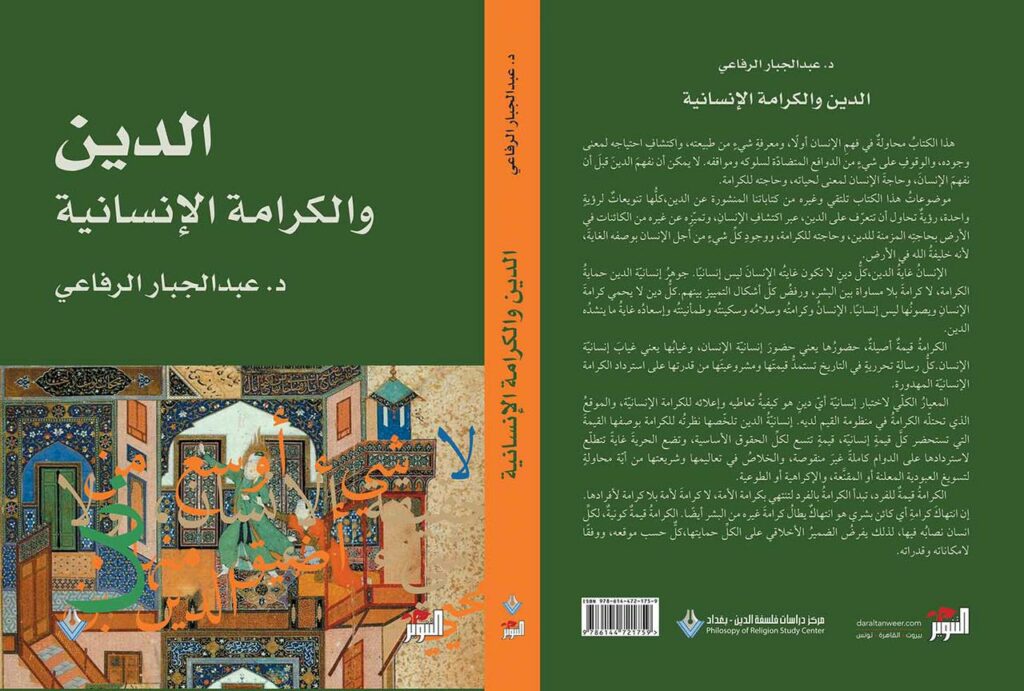
د. عبدالجبار الرفاعي
في حديثا عن العبودية بأقنعتها الحديثة، أشرنا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تشكّل مفهومِ الفرد وتكريسِه، بغيةَ استردادِ كرامته المهدورة، وفضح وسائل عبوديته الجديدة، وتفكيك البنى المتجذرة للتسلط والاستبداد. اقترن حديثُنا بخطورة تفشّي الفردانية المطلقة كحالة مضادّة لما نعنيه بمفهومِ الفرد، وكيف أن الفردانيةَ المطلقة تفضي إلى اللامسؤولية، وأخيرًا تنتهي إلى تَبَرُّمٍ ومَلَل وسأم مُنهِك، وشعورٍ مرضي بلا جدوى كلِّ شيءٍ وعبثيته.
مفهومُ الفرد غير مفهوم الفردانية المطلقة التي يتحلّلُ فيها الفردُ من أية مسؤولية أخلاقية نحو مجتمعه، ويعيش متوحِّدًا لا صلةَ له بغيره. الفردانيةُ المطلقة ضدّ طبيعة الإنسان بوصفه كائنًا اجتماعيًا عاطفيًا، صلاتُه الأصيلة بغيره تحقّق وجودَه وتثريه، وتمنح حياتَه معنى. الإنسانُ يشقى عندما يعيش منكفئًا على ذاته، لا يتصل بأحد، ولا يتصل به أحدٌ من الناس، لا يُشعرُه أحدٌ بمحبتِه الصادقة وعطفه، واعترافِه بأفعاله ومواقفه ومنجزاته. ويكشف التهافتُ على وسائل التواصل، وكثافةُ النشرِ في تطبيقاتها، حاجةَ الإنسانِ الشديدةَ للغير.
الفردانيةُ المطلقة ليست قيمةً إنسانية، لأنها تنتهي إلى مواقفَ أنانية لا مسؤولة حيالَ قضايا الإنسان الأخلاقية العادلة. الفردانيةُ المطلقة تضيعُ معها القيمُ السامية للمحبة والتراحم والعطاء والإحسان والإيثار والوفاء والتكافل والتضامن، وهي قيمٌ تتفسخُ العلاقاتُ الاجتماعية بفقدانها، وتضمحلّ كلُّ المعاني الجميلة المُلهمة في الحياة باختفائها. باختفائها يختفي تقديرُ الإنسان لذاته، عندما لا يجدُ مَنْ يقدّره أو يعترفُ به أو يعطف عليه، ويتبدّد كلُّ معنىً يمكن أن يمنحه بناءُ مفهوم الفرد للإنسان.
إن تهديمَ الصلات الإنسانية، وعدمَ الشعور بأية مسؤولية حيال القضايا الأخلاقية العادلة ينتهي إلى عزلةٍ وتشرّد، لا يرى فيها الإنسانُ إلا ذاتَه الكئيبة، وهي تتخبّط في تيهٍ لا ترى فيه أيَّ معنىً لوجودها. الفردانيةُ المطلقة تعني أن ينفي الإنسانُ نفسَه بإرادته عن مجتمعه وعالَمه الخاص. الفردانيةُ المطلقة تنتهي إلى أنانية مطلقة، الفردانيةُ المطلقة تُنتِج اغترابًا اجتماعيًا، الاغترابُ الاجتماعي يُنتِج اغترابًا وجوديًا، في الاغتراب الوجودي يفتقد الإنسانُ الشعورَ بالأمان.
شيوعُ الدعوة للفردانية المطلقة لدى بعض المثقفين جعلهم يتشبثون بأقوالٍ لفلاسفة ومفكرين وأدباء غربيين، صارت تجري مجرى الأمثال والمسلّمات النهائية في ثقافتنا، بلا تدقيقٍ وغربلةٍ وتمحيص، ومنها قولُ جان بول سارتر “الآخرون هم الجحيم”، الذي تفشّت شعاراتُه وكتاباتُه كموضةٍ ثقافية في بلادنا منتصف القرن الماضي، بنحوٍ أضحى معبودًا عند بعض الأدباء والفنانين، ربما لأننا أمةٌ شاعرة، تتلذّذُ بالفكرة التي تتخذُ من الشعار لافتةً، ينامُ خلفَها العقلُ ويخرسُ اللسان. لم يحضر هيدغر الفيلسوف الرؤيوي العميق كحضورِ مقولات وشعارات سارتر الأديب الفيلسوف. أخطأ سارتر عندما نظر إلى بُعدٍ واحد في العلاقات الإنسانية، نظرَ سارتر إلى بُعد الشرِّ الأخلاقي الذي يصدر عن الإنسان الآخر، لم ينظر إلى بُعد الخير، ولم يتنبّه إلى أنهكما يصدر الشرُّ عن الإنسان يصدرُ الخيرُ أيضًا.
الإنسانُ لا يطيق العيشَ من دون الآخر، الآخرُ يمكن أن يكونَ نعيمًا أحيانًا، مثلما يمكن أن يكونَ جحيمًا أحيانًا أخرى. الآخرُ النعيمُ يعبّرُ عن حضوره بشفقة وعطف ومحبة وحنان وتراحم وعطاء الآباء والأمهات والأبناء والازواج والعائلة، وتضامن الأصدقاء الصادقين في علاقاتهم الإنسانية. من دون الآخر لا يتحقّق تقديرُ الذات والاعترافُ والمحبة والرحمة والشفقة والعطف والتراحم والتضامن، ولا نتلمس حضورًا للقيم السامية في الحياة بمعناها الأخلاقي الجميل.
لا شيءَ نهائي ومطلق بالنسبة للإنسان، مادامت الطبيعةُ الإنسانيةُ ملتقى الأضداد فإن تحقيقَ التوازن صعبٌ جدًا بين العقل والروح والقلب، وبين مصالح وحريات وحقوق الفرد ومصالح وحريات وحقوق غيره. تطغى الفرديةُ، إن لم تنضبط بمعايير أخلاقية، ولم يرسم لها القانونُ حدودًا تتحقّق فيها عدالةٌ اجتماعية، تُضمَن فيها حقوقُ الفرد في إطار حقوق الكلّ. غالبًا ما يُنتِج تكريسُ مفهومِ الفرد وتجذيرُه فردانيةً مطلقة، لا يكترث الفردُ معها بما يفرضه الضميرُ الأخلاقي عليه نحو الإنسان الآخر، عندما لا تضبط الفرديةَ القوانينُ العادلة. وذلك ما نراه في دول غربية ترى حقوقَها، من دون أن ترى حقوقًا لناس آخرين يعيشون على الأرض خارجَ حدودها، على الرغم من أن الكلَّ شركاءُ في كلِّ الحقوق الإنسانية. وهذا مثالٌ لما تنطوي عليه طبيعيةُ الإنسان من أضداد تفرض مواقفَ متضادّة.
بناءُ مفهوم الفرد يقعُ بين حدّين متضادين، حدٌّ يضيعُ فيه الفردُ، إن تمادى في فردانية مطلقة، يتحلّلُ فيها من أية مسؤولية أخلاقية حيالَ الإنسان الآخر. وحدٌّ يضيعُ فيه الفردُ إن تم تذويبُ ذاته في غيره، والقضاءُ على شخصيته خارج إطار ما تراه العائلةُ والجماعةُ والسلطة، فيضيع تقديرُه لذاته وحرياتُه وحقوقُه الشخصية.
لا يتكرس الانتماء الإنساني بوصفه مشتركًا بشريًا من دون قبول الاختلاف والتنوع بين الناس. لا معنى لمجتمع تعدّدي من دون بناءٍ لمعنى الفرد، الحقُّ في الاختلاف هو الفضاءُ الطبيعي لتشكّل وتطور مفهوم الفرد،كلُّ مجتمعٍ يتأسّس على معتقدات وثقافة وتقاليد تتنكر للاختلافات بين البشر، يُجهَض فيه أيُّ مسعى لبناء مفهوم الفرد قبل أن يولد. لا يمكن تشكّل مفهوم المواطن من دون تشكّل مفهوم الفرد.
الاختلافُ قانونٌ كوني مشتركٌ بين كلِّ البشر. الإنسانُ ليس صخرة أو شيئًا ماديًا أو آلة ميكانيكية، الإنسانُ ليس حيوانًا أو نباتًا أو كائنًا حيًّا، الإنسانُ إنسانٌ لا غير، إنه كائنٌ مختلفٌ عن كلِّ ما خلقَ اللهُ في العالَم. البشرُ مختلفون في كثيرٍ من تكوينهم النفسي والتربوي والثقافي والاعتقادي والجسدي، إلى الحدّ الذي نرى فيه كلَّ إنسان نسخةً فريدة ذاتَ بصمة خاصة لن تتكرّر أبدًا في العالَم، منذ أول إنسان إلى اليوم، وإذا لبث الناسُ على تكوينهم الوراثي المعروف، ولم تتلاعب في هذا التكوين هندسةُ الجينات، يلبث كلُّ إنسان غيرَ قابل للتطابق مع غيره مهما كانت قرابةُ الدم بينهما، ولن تجد شخصًا يشبه غيرة بكلِّ شيء حتى آخر شخص في هذا العالَم.
كلُّ تعدّديةٍ دينية وثقافية وسياسية لابدّ أن تبدأ بتشكيل مفهوم الفرد، وتعمل على تجذيره تربويًا ونفسيًا وأخلاقيًا وثقافيًا. بناءُ ثقافةٍ تقوم على الحقّ في الاختلاف هي الأساسُ الذي يولد في فضائه ويتشكّل مفهومُ الفرد.
لا معنى لمجتمع تعدّدي متنوع من دون بناء مفهوم راسخ للفرد، ولا معنى لمفهوم الفرد من دون تبجيل كرامة الفرد وتكريسها بوصفها قيمةً إنسانية مرجعيةً عليا تعلو على كلّ قيمة. يضمحلُ معنى الفرد في كلِّ مجتمع تسودُ حياتَه رؤيةٌ واحدةٌ للعالَم، ومعتقدٌ واحد، وفهمٌ واحد للحياة، ونمطٌ واحد للتفكير، وسلوكٌ واحد. مثلُ هذا المجتمع كأن الكلَّ فيه مرايا تعكس صورةً واحدة، ينطمسُ فيها كلُّ اختلاف وتنوّع. وينتهي ذلك إلى حجب المواهب وضمورها، وانسدادِ منابع إلهام العطاء الخلّاق والابتكار والابداع، الذي لا يترسخ إلا بالتفكير المختلف، تفكيرٌ لا يكررُ الايقاعَ المشترك للكلِّ، ولا يكون صدىً لصوتٍ واحد.



